عالم الأمس - ستيفان تسفايج
ليتني كنت أعمل محاضراً في إحدى الجامعات حتى أُدرِس هذا الكتاب أو على الأقل بضعة فصول منه. لست على يقين من نجاحي إذ سأخرج في كل مرة عن الدرس فأرتحل من استعارة إلى بيت شعر إلى قصيدة هايكو إلى قصة إلى أغنية إلى لوحة فنية إلى مشهد في فيلم إلى ذكرى حتى ينقضي الوقت دون حديث أكاديمي. فإذا وجدت مثلاً كلمة الزمن شردت بعيداً ورحت أحذر الطلبة من "أشد الحيوانات الأليفة ضراوة: الساعة الحائطية" التي اتهمها ماريو كوينتانا بالقتل المتعمد لثلاثة أجيال من عائلته، ثم رحت أردد ببطء شديد كمن يتهجى ما كتبه ساباتو في روايته الضخمة (أبطال وقبور): "وهكذا انقضى يوم آخر، يوم لا يمكن استرداده، يوم يقرّبه أكثر إلى حتفه". ولأنهم في عنفوان الشباب لن يصدقوني وهكذا سأضطر أن أحكي لهم عن أسطورة الملاكمة محمد علي حين راح يتباهي في نزاله الأول قائلاً إنه مايزال يافعاً حتى إنه لم يحلق ذقنه بعد على عكس خصمه الكهل. سيفوز محمد علي بلقب بطل العالم وتمضي أكثر من عشرين سنة فيطيح به ملاكم تافه ليعلن اعتزاله النهائي هذه المرة. قال بأسى: "لقد تلقيت من الضرب ما يكفي لأعتزل، كنت أرى الضربات في طريقها دون أن أتمكن من تفاديها، لقد نال مني الزمن." ثم أسأل هل تعرفون الكرنك؟ الأغنية لا المعبد. في المقدمة الموسيقية التي أعدها عبدالوهاب ضربات صغيرة لآلة القانون شبهها الشريعي عمار بدقات القلب أو الساعة والمقصود أن تمنحنا انطباعاً بمرور الزمن ثم أشعر بلا جدوى كل شيء فأصمت. لطالما لفت انتباهي عندما كنت طالباً خروج الدكتور عن الدرس فإذا عاد أعرضت عنه. ربما لن يلتف حولي الطلبة، بل لعل الأوغاد يبتكرون لي لقباً مهيناً فيتداولونه مثل السجائر وما إن يصل إلى أحد الدكاترة حتى يمررونه خفيةً بينهم متضاحكين كلما دخلت القاعة. سرعان ما سيستدعيني عميد الكلية فيسألني بنبرة لا تخلو من التهديد عن المنهح الأكاديمي فلا يطول بي المقام أكثر من فصل دراسي. كان أبي في الزمانات شديد التقدير للدكاترة، والحق أن لشهادة الدكتوراة في ذلك الزمن البعيد شيء من الجلال، ربما لجدتها أو لندرتها، كانت ترفع حاملها واليوم تحط من شأنه إذ كشف بعضهم عن إدراك هو أقل بكثير من إدراك رجل الشارع. كان غازي القصيبي قد بدد منذ زمن في سيرته البديعة هذا الوهم الرومانسي حين أكد أن لا عبقرية في الدكتوراة إنما هي جهدٌ أكبر. في حرم جامعة ساوثامبتون بُحتُ لأحد الأصدقاء برغبتي القديمة في التدريس الجامعي فأخبرني أن الفرصة ما تزال سانحة فأحجمت عن إخباره بأنني ما رغبت في ذلك إلا لانتزاع نظرة الإعجاب من أبي، أما وقد دفنت تلك النظرات فقد دفنت معها تلك الرغبة أيضاً. لكن شيئاً في النفس ظل يظهر بين الفينة والأخرى إذ وجدت بداخلي ميلاً خفياً للدكتورات. كانت الدكتورة رشا خريجة السوربون تنزعج من نظراتي إذ أجلس في القاعة فأنظر إليها في مناجاة كما لو كنا عاشقين في مقهى، ولما كانت حديثة التخرج وصغيرة في السن، إذ كنت في سنها أو أكبر كانت تدفع عينيها بعيداً عني كلما اشتبكت نظراتنا فأستغرق في النظر إليها بينما تربط مخبوزاتها الفرنسية بزنار من الليلك. كانت في وداعة جنين يتهادى على شاشة السونار. كلما مشت راح يتبعها الصباح مثل قطة ليشم كاحلها، ويتأرجح الطريق لشعوره بدوار البحر، وتنحني ناطحة السحاب مثل عمود إنارة. كانت تمشي بسرعة سبعة أغنيات على مقام العجم في الساعة فتُنزه في طريقها خط الاستواء كما لو كان كلباً من فصيلة بابليون. كلما مشت منحت الكرة الأرضية سبباً وجيهاً للدوران. لا عجب أنها كانت تتحسس أزرار معطفها وقد راحت عيناي تحاولان خلعه، وأحسب جهلاً وغروراً أني لا الصيف من كان يدفعها إلى التعرق خجلاً وفتح الشبابيك. ربما كانت أحلامي الليلية كوابيسها، من يضمن اللاوعي؟ على كل حال لقد غازلت بعدها الدكتورات بقصد وبدون قصد وأول من تمنع منهن كدت أتزوجها. بعد هذا الهذر لا شك أني لا أصلح للتدريس، لكني سأضع لكم قليلاً من المقتطفات من "عالم الأمس". لعل من المعلوم أن تسفايج قد انتهى به المطاف منتحراً بعدما كتب رسالة قصيرة يودع فيها الأصدقاء ويتمنى ألا يتأخر عليهم طلوع الفجر. لكن "عالم الأمس" في نظري هي رسالة انتحار تسفايح التفصيلية.
تسفايج متحدثاً عن أبيه:
"وما كان يفخر به في حياته هو أن أحداً لم يشاهد اسمه على سند أو حوالة، وأن بيانات حسابه كانت دوماً في الجانب الدائن، وقد أصر على رفض أي تكريم أو منصب. كان اعتزازه الخفي الذي عنى له أكثر من أي اعتراف خارجي هو بأنه لم يطلب شيئا من أحد ولم يتوجب عليه أن يقول لأحد "شكرا" أو "من فضلك"."
وعن زمن التسامح الغابر:
"فالكراهية بين البلدان والأمم لم تكن قد أخذت تثب يومياً من الصحف، وتوقع الشقاق بين الشعوب والأمم. وتقوي مشاعر القطيع عند العوام إلى هذا الحد المقزز في الحياة العامة. والحرية الشخصية التي لم تعد مفهومة الآن كانت من المسلمات، وما من أحد كان يزدري التسامح كما يُزدرى اليوم باعتباره ضعفاً وليونة، بل كان يمدحه باعتباره قوة أخلاقية".
وعن زمن البطء والأناة:
"ولا أذكر أنني رأيت والدي يرتقي أو يهبط الدرج ركضاً، أو يتعجل في عمل شيء. فالعجلة لم تكن تعتبر سلوكاً فظاً فقط، بل غير لازمة بالفعل، فذلك العالم لم يكن يحدث فيه أمر غير متوقع".
وعن الاستغراق في الفن والغفلة:
" لم نلحظ نحن الشباب إلا القليل من التغيرات الخطرة في بلادنا. كنا لا نرى إلا الكتب واللوحات ولا نهتم بالسياسة والمشكلات الاجتماعية. ومثل الملك بلشصر ألهتنا أطباق الفن الفاخرة عن النظر القلق إلى المستقبل. ولم ندرك إلا بعد عقود وحين تهاوى السطح والجدران علينا أن الأسس قد نُسِفت منذ أمد طويل".
وعن ريلكه:
"لقد بدا أن الصمت ينمو حوله أينما ذهب. كان يتجنب الضجيج ويتجنب حتى شهرته ذلك "الكم من سوء الفهم الذي يتجمع حول الاسم" كما قال ذات مرة. لم يكن له منزل ولا عنوان ولا مسكن ولا محل إقامة ثابتة. كان دائم الترحال في العالم ولم يكن يعلم مقاصده أحد ولا حتى هو نفسه. فكل قرار وتخطيط يثقل روحه البالغة الرهافة، كان المرء يلتقيه بالمصادفة على الدوام. ربما مر به آلاف المارة من غير أن يتخيلوا أنه شاعر، وأنه أعظم شعراء جيلنا. لم يدع شيئاً يغادر يديه قبل أن يكتمل".
وعن رهان الصواب:
"ولكن الإيمان الأعمى بأن العقل سوف يكبح الجنون في اللحظة الأخيرة تأكد أنه قصورنا الوحيد. صحيح أننا أحسنا الظن بالكتابة على الجدران، ولكن أليس هذا جوهر الشباب ألا يكونوا مرتابين بل مؤمنين؟ لقد اعتقدنا أن عمال السكك الحديدية سيفضلون قطع الخطوط على نقل رفاقهم إلى الجبهة مثل الأنعام، وعولنا على أن النساء اللواتي توقعنا أن يرفضن التضحية بأولادهن وأزواجهن على مذبح مولوخ".
وعن عجز الفنون:
"ومن الواضح أن الظلامية ناشطة، والمعركة ضدها أهم من فننا. شعرت برومان رولان يتفجع لأن هشاشة البناء الدنيوي كانت مرارتها مضاعفة، هذا الرجل الذي احتفى عمله كله بخلود الفن قال: "إن الفن يمنحنا العزاء كأفراد، إلا أنه لا قِبل له بالواقع".
وعن جنون مدائح الحرب:
"فالحكمة الوحيدة للفلاسفة كانت الإعلان عن أن الحرب هي حمام من الفولاذ يصون قوة الشعب. ووافقهم الأطباء في ذلك، فاستفاضوا في الثناء على جراحاتهم الترقيعية بحيث كاد المرء يغرى ببتر إحدى ساقيه السليمتين واتخاذ واحدة صناعية بدلاً منها".
وعن الهياج الحتمي:
"ولكن لم يمض وقت طويل حتى اتضح هول الكارثة التي سببتها مدائح الحرب وعربدات الكراهية تلك. كانت كل الأمم المتحاربة في حالة انفعال مفرط. كانت أسوأ الإشاعات تتحول فوراً إلى حقيقة، وأسخف فضيحة تلقى التصديق، فالحرب لا تجيز لنفسها أن تتساوى مع العقل، فهي تحتاج إلى حماسة وكراهية."
وعن النظرة الضيقة:
"وسرعان ما أصبح مستحيلا أن تجري حديثاً معقولاً مع أي واحد في الأسابيع الأولى من حرب ١٩١٤. والأصدقاء الذين اعتبرتهم ذوي فردية محددة تحولوا إلى وطنيين متعصبين. كانت محادثتهم تنتهي بجملة سخيفة مثل: "من لا يكره لا يحب" أو بتجريم فظ. ثم إنهم أشاروا إشارة محذرة إلى أن اعتبار الحرب جريمة يجب تنبيه السلطات له، لأن الانهزاميين كانوا أسوأ خونةٍ للوطن".
وعن جمال الطبيعة في السلم والحرب:
"وفي البلد الذي يخوض حرباً يبدو إيقاع الحقول الهادئ في عين الحزين لا مبالاة متعالية من جانب الطبيعة، ويستحضر كل غروب أرجواني مشهد الدماء المسفوكة. أما هنا حيث يعم السلام، فإن عزلة الطبيعة المهيبة قد غدت طبيعية".
وعن الفقر المدقع ما بعد الحرب:
"وكل ما لم يكن مثبتاً بالمسامير كان يختفي".
وعن استشعار الخطر قبل وقوعه:
" أما أنا فقد عانيت الكارثة مقدماً في خيالي، ثم عانيتها عندما وقعت. توقفت عن تحذير الناس في اليوم الثالث. لماذا أزعجهم؟ ولما اجتاز القطار حدود النمسا عرفت كما عرف لوط في الكتاب المقدس أن كل ما خلفته وراءي كان غباراً ورماداً، ماضياً تحول إلى عمود من الملح".
وعن حرية العالم القديم:
" ووجدت نفسي أفكر على الدوام فيما قاله لي أحد المنفيين الروس: "كان الإنسان في الماضي له جسد وروح، أما الآن فهو يحتاج إلى جواز سفر أيضاً وإلا لن يُعامل معاملة الكائن البشري". وبالفعل لا شيء يجعلنا أكثر إحساساً بالارتداد الهائل الذي هوى فيه العالم بعد الحرب العالمية الأولى أكثر من تقييد حركة الإنسان وتناقص حقوقه المدنية. ويسرني دائما أن أروي للشباب المندهشين أنني سافرت قبل عام ١٩١٤ من أوروبا إلى الهند ثم إلى أمريكا بلا جواز سفر. كان المرء يركب وينزل من دون ارتياب ولا مساءلة. لم يكن قد بدأ بعد رهاب الأجانب، الكراهية المَرَضية للأجنبي أو الخوف منه. إن كل ختم على جواز سفري وصمة عار، وكل واحد من تلك التحقيقات والتفتيشات إهانة، إنها مجرد تفاهات في زمن كان هبوط القيم الإنسانية فيه أسرع من هبوط العملات."
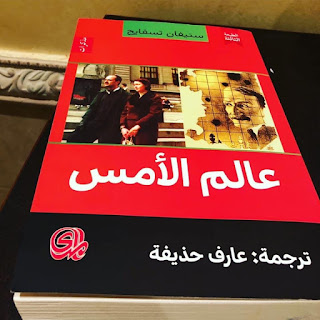



تعليقات
إرسال تعليق