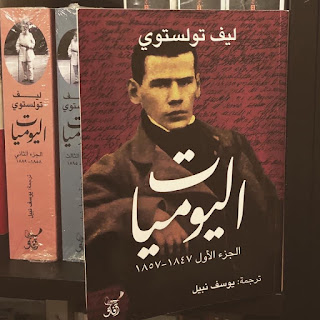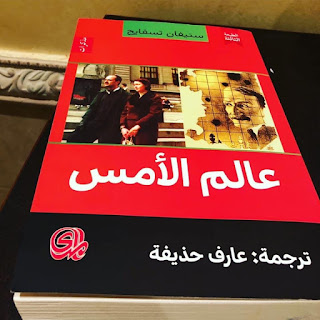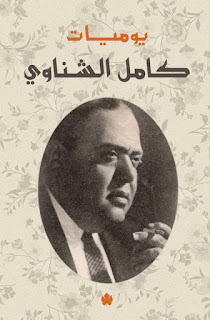ما حدث وما لم يحدث..

-١- خرج. نزل عبر السلالم. توقف. تحسس جيبه. مسدس. توقف مرةً أخرى. قطع الشارع. سيارة. حادث. قتيل. -٢- ما أكبر بهجة العين حين تنظر إلى امرأة تحجب ضحكتها بيدها. منظرها لا يختلف كثيراً عن الغروب أو البحر أو الغيوم في نافذة الطائرة أو كل ما يدعو إلى التأمل وتحنيط الزمن. لكن الفزع هذه المرة هو من يضع يد المرأة على فمها كأنما ليكتم صرختها أو يؤجلها. لقد رأت السيارة ترتطم بالرجل ليرتفع بضعة أمتار في مشهد كان ليغدو رائعاً في ألعاب القوى. لقد قفز ببراعة، وبدون زانة، فوق ذلك الحاجز الذي يفصل بين الحياة والموت. هوى في العالم الآخر مثل طائرة منكوبة ونجا مسدسه بأعجوبة. -٣- لا تَقتُل، فإن كان لا بد فليس بالسكين، ليس في المرة الأولى على الأقل. تذكر ذلك. ما أسهل المسدس، سبابة صغيرة وينتهي الأمر. الدم بعيد وأنت كذلك. يمكنك حتى أن تغمض عينيك، في مونتاج مريح، فلا تشهد تلك اللحظة. لكن لا بد للسكين من قبضة قوية، وذراعٍ مشدود، وعينين يقظتين، وما يكفي من الكراهية لتمضي في القتل ثم لا تندم. يطيش الرصاص أما السكين فلا. تشق طريقها في الجسد، تجوس في اللحم، تقطع الأنسجة باللذة التي تقطع فيها شرائح الأناناس. لقد صن